في المغرب الآن، لا ننطلق في قراءتنا لما يكتبه الصحافيون من أي خلفية شخصية، ولا نتعامل مع النصوص بوصفها مواقف لأشخاص، بل كمادة تحليلية تكشف عن اتجاهات فكرية، وإشارات رمزية، وصدى لمواقف واصطفافات ضمن مشهد عام يطغى عليه الضباب وتُستلب فيه الدلالة.
لهذا، نقرأ اليوم مقال الزميل يونس مسكيني لا لنصادره أو نُصنّفه، بل لنفكك بنيته الخطابية، ونستخرج منه ما قيل، وما لم يُقَل، أو ما يُراد له أن يُفهم على نحوٍ معين.
1. بنية المقال: تجميع رمزي لحالات “المقاومة”
المقال يُبنى على استدعاء مكثف لصور المقاومة، في الفن والسياسة والرياضة، ويجمعها في حزمة واحدة، كما لو أن الرباط بين حفلة “طوطو” واحتجاج أساتذة علم الاجتماع ومباراة نهائي كأس العرش، هو رابط من جنس واحد: “مقاومة الرداءة والسلطوية”.
هذا الربط الرمزي ليس بريئًا، بل يُخضع وقائع معقدة ومتباينة لتركيب تأويلي يريد من خلالها الكاتب تثبيت أطروحة رئيسية: أن الأمل في المغرب يُصنع من الهامش، من قاع المجتمع، ومن ردود الفعل العفوية التي تتحدى موازين القوى.
2. فوز آسفي كـ”حدث كاشف”: هل الرياضة مرآة السياسة؟
حين يتحدث الكاتب عن أن “نهضة بركان” تمثل في المخيال الشعبي نفوذ فوزي لقجع، ويقابلها بـ”أولمبيك آسفي” بوصفه صوت الهامش والانتصار على الجبروت، فهو لا يقدم تحليلاً رياضيًا، بل يشحن المباراة بدلالة سياسية وشعبوية ثقيلة.
غير أن ما يُسجَّل هنا، هو هذا التعميم الرمزي: هل مجرد فوز آسفي هو انتصار على الدولة/السلطة؟ هل يجب أن تُقرأ كل مباراة وفق منطق المركز والهامش؟
ثم ما المقصود حين نقول إن لقجع ارتبط في “المخيال العام” بالنفوذ؟ هل تم ذلك نتيجة أداء رياضي أم بفعل الحملات الإعلامية والسياسية؟ وهل من الإنصاف إسقاط موقع لقجع المؤسساتي على فريق رياضي دون أدلة دامغة على تدخل أو تحكّم؟
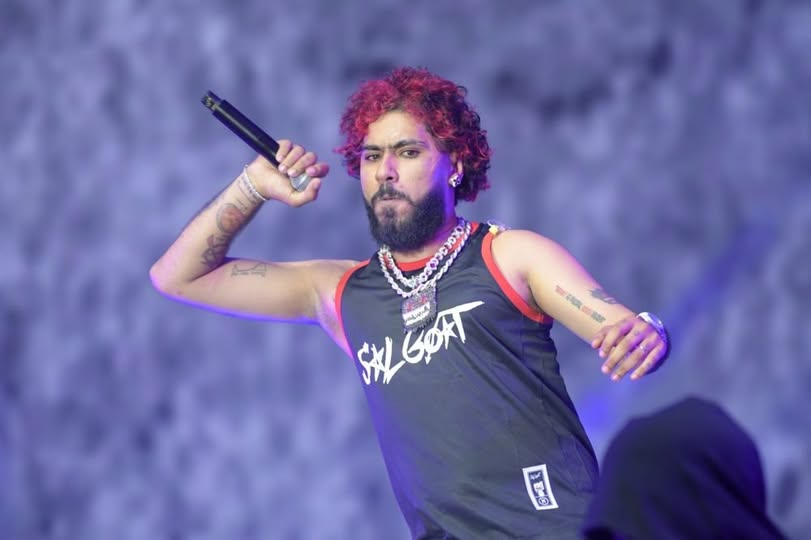
3. حفلة “طوطو” والتطبيع الأكاديمي: مزج لا يخلو من انتقائية
يُدخل الكاتب حفلة موسيقية مثيرة للجدل ورفض مشاركة أكاديميين إسرائيليين في مؤتمر، ضمن خانة واحدة، ويعتبرهما تعبيرين عن مقاومة ثقافية. لكن المفارقة أن السياقين مختلفان:
-
الأول يتعلق بالحرية الفردية والاختيار الفني.
-
الثاني بموقف سياسي-أخلاقي ضد الاختراق الإسرائيلي.
فهل من الدقة المقارنة بين من يرقص في مهرجان موسيقي، وبين من يخوض معركة ضد الأكاديميا الصهيونية؟ ألا يُفرغ هذا الربط فكرة المقاومة من عمقها السياسي الحقيقي؟

4. السياسة كخلفية عامة: عودة بنكيران ولشكر وبنعبد الله
يُفرد الكاتب فقرات لأبرز الخرجات السياسية الأخيرة، ويُظهر تبايناتها ليؤكد أطروحته: أن المغرب لا يزال يتنفس تعددية واختلافًا. لكنه لا يناقش مدى جدية هذه الخرجات، ولا يسائلها، بل يضعها ضمن مشهد “الصراخ الممكن”، لا صراع المشاريع.
وإن كان في هذا تمجيدٌ للحد الأدنى من الحركية السياسية، فإنه يغفل واقع الأزمة الأعمق: غياب التأثير الحقيقي لهذا الصراخ، ومحدودية أثره في السياسات العمومية.
5. ما الذي لا يُقال؟
-
لا يُقال إن فوز آسفي، بقدر ما هو إنجاز رياضي، لا يُنتج بالضرورة تحولًا في موازين السلطة.
-
لا يُقال إن ربط كل حراك أو اختلاف بمفهوم “المقاومة” قد يؤدي إلى التضليل أو التهوين من معارك المقاومة الحقيقية ضد السلطوية.
-
لا يُقال إن شخصنة القضايا (لقجع، طوطو، بنكيران…) تخفي أبعادًا بنيوية تتعلق بالحكامة، والمحاسبة، والفعالية.


